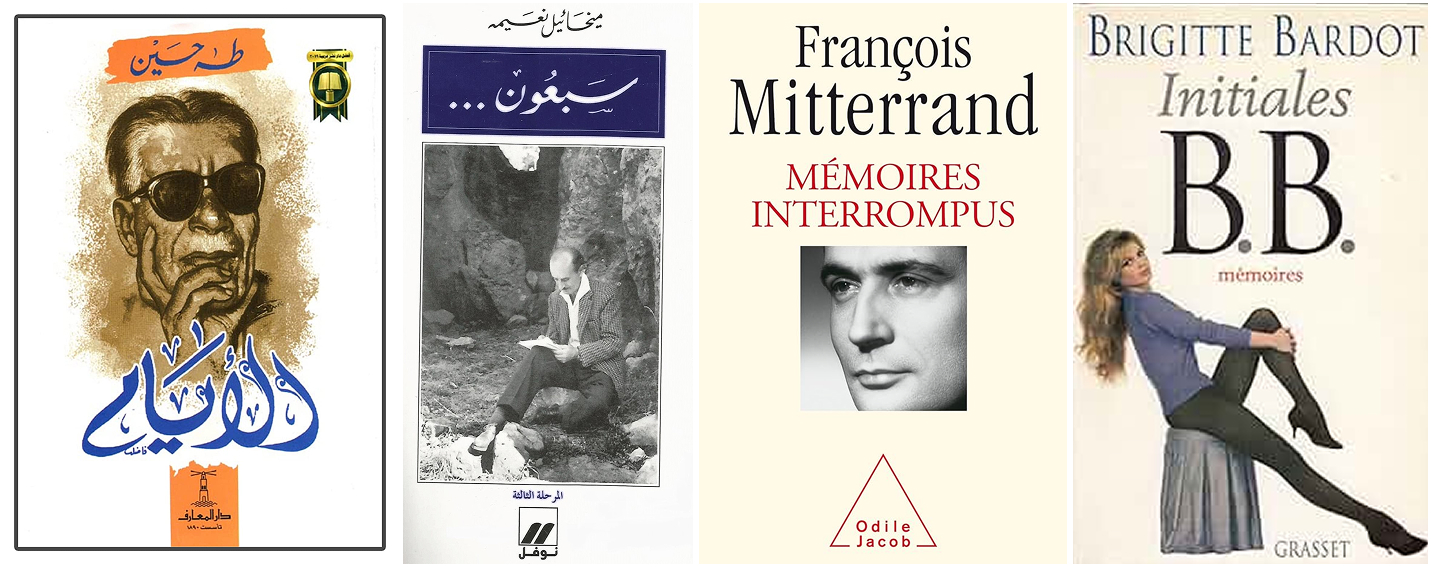الزمن المسرحيّ الضائع

لا أستطيع أن أتذكّر اسم المسرحيّة التي جعلتني أهرب من الصالة، وأنا ألعن مبدأ "التجريب" الذي يريد أن يجرّب فينا كافّة أنواع الرعب، نحن الخارجين من الحرب مثخنين بجراح نفسيّة وأعطال عقليّة. والمسرحيّة كانت فعلًا عن الحرب والموت والجثث، ترافقها مؤثّرات صوتيّة نجحت والحقّ يقال في إحداث التأثير المطلوب. ومنذ تلك الليلة أصبت بنوع من رهاب المسرح. وكثيرًا ما استعددت لمشاهدة مسرحيّة قرأت عن نجاحها وأثق بقدرات مؤلّفها ومخرجها والممثلّات والممثّلين فيها، ولكنّي كنت في اللحظة الأخيرة أعطي بطاقة الحجز لمن يرغب في تجربة "التجريب"، وأنا أتنفّس الصعداء كما تنفست في تلك الليلة المشؤومة حين عانقني هواء الشارع.
قبل تلك الأمسية، حدث لي ما يشبه ذلك، وكانت خشبة المسرح في وسط الجمهور ولا باب للخروج سوى المدخل الرئيسيّ، فعبرت وسط الممثّلات والممثّلين لأهرب غير آبهة بنظرات المشاهدين المستهجنين.
ومع ذلك كنت، بين هاتين الحادثتين، أتنقّل بين العروض المسرحيّة مبتهجة بحركة كلّها بركة. كان ذلك في تسعينيّات القرن العشرين، وكانت بيروت تستعيد أنفاسها، والمصارف ترعى الأعمال من دون أن تعلمنا بأنّها ستكون بطلة العرض الأخير وسنقع نحن ضحاياها في أكبر عملية احتيال لا تخطر على بال مخرج سويّ، وأبعد ما يكون عن عالم الفنّ النقيّ.
بطاقات الدخول إلى المسرح كانت عهدذاك أنيقة وملوّنة، وكذلك الكتيّبات التي تعرّف بالعمل وفريق الإعداد والتنفيذ، واعتدت مذ بدأت علاقتي بهذا الفنّ أن أحتفظ بها كلّها. ثمّ بدأت أعود إليها حين أرغب في تلمّس مخمل المقاعد التي كنّا نجلس عليها، والغرق في عتمة الصالة وتصويب الفكر كما الحواس مجتمعة نحو الخشبة حيث تولد الحكاية. أنظر إلى كلّ بطاقة وأحاول أن أتذكّر مع من شاهدت تلك المسرحيّة أو ذلك العرض الغنائيّ. أليس هذا ما يقوله لنا أنطوان كرباج حين يدعونا للاستماع إلى أغنية فيروز "نحنا والقمر جيران" وتذكّر الأجواء التي كنّا فيها يوم استمعنا إليها أوّل مرّة ومن كان برفقتنا؟
جبّارون أولئك المسرحيّون الذين يستمرّون اليوم في العمل، متحدّين الصعوبات الماديّة ومراهنين على جمهور يكاد يكون هو نفسه وأغلبه من طلّاب الفنون في الجامعات، أو منتظرين مواسم "الإقلاع عكس الزمن"* حين يأتي المغتربون ويريدون الترفيه عن أنفسهم. ولكن هل يعني ذلك أنّ الحركة المسرحيّة بخير؟ وأنّ الجمهور المسرحيّ يملك من النضج ما يكفي كي يعرف القيمة الحقيقيّة لهذه المسرحيّة أو تلك؟ ففي غياب النقد العلميّ المتخصّص تبقى المقالات الوجدانيّة العاطفيّة عرضة بدورها للنقد كونها تقع غالبًا في فخ المسايرة والمحاباة وصادرة أحيانًا عن كتبة طارئين لا يعرفون تاريخ المسرح اللبنانيّ كي لا نقول العالميّ.
لا شكّ أنّ المال غير متوفّر لإنتاج مسرحيّات ضخمة تتطلّب عناصر بشريّة كثيرة، وإمكانات تقنيّة حديثة فضلًا عن الديكور والملابس والموسيقى والإضاءة والصوت والإعلان وتصميم الرقصات في حال كان العمل استعراضيًّا. ولهذا تكاد الأعمال تنحصر بممثّل أو اثنين أو خمسة على أكثر تقدير مع ديكور متواضع بسيط. من هنا يتحمّل النصّ الثقل كلّه، وعليه أن يعوّض النقص في الإمكانات الماديّة بما يناسب كي لا تقع الأعمال المسرحيّة في الرتابة والتكرار. لذلك نجد، ومع الاحترام الواجب لممثّلات وممثّلين يبرعون اليوم في أدوارهنّ وأدوارهم، أنّ الكلمات، في عمل مسرحيّ ناجح، هي التي تحمل الأجساد وتملأ الفضاء معاني ونهفات ورسائل ورقصات.
أعود إلى ألبوم بطاقات المسرح. أتأمّلها بمزيج من الحنين والحسرة: حنين إلى زمن كانت المسرحيّات فيه تُعتبر حدثًا ثقافيًّا بارزًا تتلقفه الصحف والمجلّات، وحسرة على فنّ يبحث عن رؤوس أموال تؤمن به في غياب أيّ دعم من وزارة الثقافة. وأتأسّف لأنّني ولدت في ستينيّات القرن الماضي فلم أواكب الحركة المسرحيّة التي طبعت تلك الحقبة، وعندما صار في إمكاني الذهاب إلى المسرح اشتعلت الحرب وأكلت الخشبة والستارة، فاكتفيت بالقراءة عن رائدات وروّاد صنعوا مجدًا بقي يتوهّج حتّى بعدما انطفأت الأضواء وخلت الصالات.
وحين حلّ السلام المترافق مع إعادة الإعمار، انتفض المسرح من تحت ركام الحرب، حاملًا آثارها وجراحها. لا شكّ في أنّ المسرح، كأيّ فنّ آخر، ابن بيئته ووريث تاريخها الثقافيّ والفكريّ والاجتماعيّ والسياسيّ، لذلك كيف له أن ينجو (وينجّينا معه)، بعد خمسين عامًا من التقاتل والموت والفساد والفقر والجنون، بغير جرعات من الحلم والفرح تساعدنا على تحمّل واقعنا. وفي الوقت نفسه عمّا ستدور المسرحيّات إذا ابتعدت عن الحرب وتداعياتها، والعاملون في هذا المجال الفنيّ ورثة أوهامها وحزنها وخيباتها وشظاياها.
ومع كلّ ذلك، تبقى التحيّة واجبة لمن يحمل ليلة بعد ليلة صليب الخشبة على منكبي فقره وشغفه، مراهنًا على عشّاق العتمة التي لا بدّ من أن ينبثق منها نور القيامة ليحمل هذا الفنّ رسالة الجمال ومسؤولية الإضاءة على هموم الإنسان وشجون الوطن، من دون الغرق في عتمة القبر والتخبّط في جحيم التنافس على السوداويّة.
*الإقلاع عكس الزمن: رواية لإملي نصرالله عن رجل لم يطق الحياة في كندا حيث أولاده فعاد إلى لبنان ليواجه الحرب التي كان الناس يهربون منها.